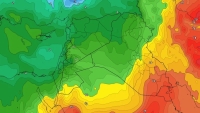تأخذ الشابات والشباب – بل الأطفال الفلسطينيون- على عاتقهم مهمة الاشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في محاولات يائسة للدفاع عما تبقى من الحياة والكرامة والممتلكات، عزلاً إلا من الغضب.
وفي الأثناء، تختبئ الجهات المتعالية، صاحبة السياسة، خلف العمل المكتبي الذي يُفترض أنه يحرر الفلسطينيين، بينما تعكف فعلياً على إدامة نفسها في السلطة.
وعلى نحو يعاكس المنطق، يفتخر الفلسطينيون بهؤلاء الفتية والأطفال الشجعان الذين ينفذون عمليات انتحارية في الحقيقة، باعتبار أن تضحياتهم تقول إن الفلسطينيين موجودون ويقاومون.
وليست العملية الأخيرة التي نفذتها طفلة في الرابعة عشرة من العمر في حي الشيخ جراح الأسبوع الماضي الأولى ولن تكون الأخيرة من هذا النوع. في كل لحظة يجد فتياننا وأطفالنا في الأرض المحتلة أنفسهم نهباً لقهر طاغٍ، بلا حامٍ ولا نصير، فيرتجلون أعمال مقاومة غير مخططة ولا متكافئة يغلب أن تنهي حياتهم فعلياً أو بالأسر الطويل.
ولو كان هؤلاء الأبناء يرتقون في سياق عام من المقاومة والاشتباك، لأمكن اعتبار استشهادهم جزءاً من الثمن الذي يتحتم أن تدفعه الشعوب المضطهدة الساعية إلى التحرر.
لكن الوجع يحيّد الفخر عندما يكون هؤلاء هم الفصيل الوحيد الذي يدافع عن وجود فلسطين في العالَم بكلفة أرواحهم ومستقبلهم، في حين يتفرج "الراشدون” الذين ينبغي أن يكون دورهم – كأي راشدين- هو الدفاع عن فتياتهم وفتيانهم وتأمين سلامتهم وإبعادهم عن خط الاشتباك.
وإذا كانت قيادة شعب مستعمر وثائر تُقدم سلامتها الخاصة، بثمن التنسيق مع العدو والعمل على هواه، على سلامة مواطنيها العُزل المضطهدين والمستهدفين، فبئس القيادة والغايات والمسعى.
وفي الحقيقة، لا يدافع هؤلاء المقاتلون قبل الأوان عن فلسطينتهم بهذه الطريقة الانتحارية بسبب تقاعد الفصائل الفلسطينية من عمل المقاومة فحسب.
إنهم يتصرفون وحدهم عندما لا يأتي كل الفلسطينيين، والعرب، والعالم لنجدتهم كما يفعلون مع حوادث العنف المنزلي وتعنيف القُصّر على الأقل.
في الشيخ جراح، مثل كل الأجزاء من الأراضي المحتلة التي توجد فيها "حكومات” و”سلطات” و”قوات” فلسطينية، يتعرض الفلسطينيون من كل الأعمار للإذلال والاعتقال والقتل على أساس يومي.
وبينما يقطع المستوطنون أشجارهم ويعتدون عليهم، وينتهك جيش الاحتلال حرمة بيوتهم ويعتقل أطفالهم ويهدم بيوتهم، لا يظهر عنصر واحد من "الأمن الفلسطيني” في المكان.
لمن هو "الأمن” الذي تقدمه هذه الأجهزة إذن؟ إنه الفقدان الكامل للأمن والشعور الغامر بالخطر هو الذي دفع الطفلة في الشيخ جراح إلى الدفاع عن نفسها بهذا الهجوم اليائس، في منطقة فيها حكومة فلسطينية، بأوراق مروسة ومراسيم وقوات شرطة.
ومن المفارقات أن "دفاع” هذه الحكومة عن شيء –عن مبرر وجودها بزعم أنه أمن الفلسطينيين- هو الاعتذار للعدو عن أعمال "العنف”، إن لم يكن "الإرهاب”، التي ينفذها الشباب والأطفال اليائسون العزل وغير المحميين، والتي لا تستطيع أجهزة الأمن الفلسطينية أن تمنعها لأنها ارتجالية.
عندما تكون أي سلطة، خاصة إذا كان يفترض أن تقود مسيرة تحرير شعب، عاجزة عن تجنيب أطفالها كلفة المواجهة غير المتكافئة ومتوقعة النتائج مع مستطونين مسلحين وجيش مدجج، فإن أي أدوار أخرى تدعيها تكون بلا معنى.
سوف يقال إنها تمارس دوراً سياسياً استراتيجياً تعرف هي أبعاده ونتائجه في اتجاه التحرير. وفي الأثناء، ليكن المدنيون الفلسطينيون العزل وحدهم بلا حماية، ولتُهدم بيوتهم ويُسجن أطفالهم ويوقَفون على الحواجز ويهانون، لأن الانضمام إليهم في المقاومة، أو مجرد امتداحها، سيحبط خطط القيادة.
لكنّ التاريخ برهن عند كل منعطف أن الاحتلال لا يُذكر إلا وتأتي المقاومة كنقيض. وإذا كانت القيادة "السياسية” أذكى مما يظهر وتعرف كيف ومتى ستحرر شعبها، فإن هناك دائماً جناح عسكري أو مقاومة منظمة موجعة تزودها بأوراق الضغط وانتزاع التنازلات من العدو.
لذلك، أكثر من الافتخار بشجاعة وتضحيات هؤلاء الصبية الذين يشتبكون وجهاً لوجه على الخط الأول مع العدو ليكتبوا بأرواحهم ومستقبلهم فلسطين في الوجود، ثمة العار من تفويض هذه المهمة الكبيرة إليهم والمشاركة في إيصالهم إلى كل هذا اليأس والقهر والوحدة والهجوم الانتحاري.
آن أن يُعاد تعريف الأدوار والمسميات والجدوى في النضال الفلسطيني. وأول ذلك، الاعتراف بأن مَن لا يتمكن من حماية أبناء شعبه ويتركهم عزلاً أمام عدو وحشي ليس قائداً ولا سلطة. بل إنه يشارك في مصارعهم لأنه يشارك في تيئيسهم إلى حد المقاومة بالانتحار.